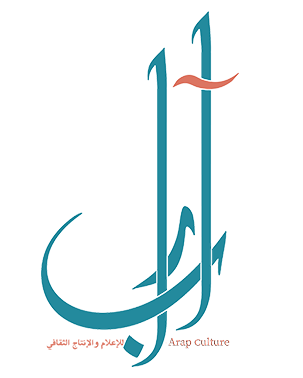جلال دادا يحرق الجسد بالماء
لوحاتي الجديدة هي العودة إلى الحياة. لا اتخلى عن تلك المرأة التي أحبّها (( أمي)).

إعداد وحوار : حسين كري بري
لوحاتي الجديدة هي العودة إلى الحياة. لا اتخلى عن تلك المرأة التي أحبّها (( أمي)).
جلال دادا من مواليد ١٩٧١ الحسكة عاش في عفرين قرية ( قطمة) ينتمي إلى المدرسة التعبيرية بجدارة ، أعماله تتناول لغة الجسد بشكل عام والأنثى – حالياً بشكل خاص ، من حيث التفاعلات والتراكمات انثروبولوجياً وبيولوجياً وسيكولوجياً وسوسيولوجياً.

الساحة الكونية التي اتخذها جلال دادا بين الحافات الأربع وطبقة من القماش ابرز فيها الوحي والرسالة إلى ماهو أبعد من العقل والتصور . والمتلقي يجد نفسه بين مدرسة من مدارس التصويرية بطريقة يتبعها الفنان . الجنون بحد ذاته موجود في اللوحة وهو الانعكاس بين الشخصتين ( جلال و الجسد) أي جسد اللوحة وارتباطه باللون وهو يحاكي التاريخ.،
جلال دادا استطاع أن يلامس الحقيقة الشرقية العميقة القاسية ، التي قضاها الجسد واللون خلف قضبان التخلف والديكتاتوريا البيئية. الريشة بين أصابعه كأغنية حب أسطوري ، عاش في السماء بين النجوم والنيازك ، له صدى في العالم الواقعي والخيالي والواقع الراهن بين مخلوقات الأرض والحوريات. الجمال الذي نجده بين ثغرات الخطوط وضربات الريشة يثري الروح ويغذي الجسد والعين ويعلو القلب إلى القمة. والعري في جسد اللوحة ماهو إلا وجود واللاوجود، هو الجحيم والجنة ، النار والماء، البساطة والغموض، إنها الثورة الهائجة في بحر الجسد ، وتحول في معانيها ومناخها حسب اللون واللغة. الأنتقال من الأجساد المحروقة والترابية إلى صفاء اللون والرمادية والتحرر من قفص العادة والتقليد بات أكثر وضوحاً من ذي قبل. تحدث جلال دادا عن الحياة بشكل عام وعن الفن والمرأة بشكل خاص في ما يلي: حاولتُ كثيراً الخروج من ذاك الجرح الذي أرقني طويلاً، ولكنني ألفته وألفني ، سكنته وسكنني … أحاول تجسيد الحياة من خلال رسوماتي عن الأنثى كونها الكائن الأكثر ضعفاً فكلما توغلتُ في جمالها لحظة الحرية ، يحاصرني ذاك العالم المدمّر الذي يعكس آلام البشرية في العالم الداخلي ، فبتُ أرسم شخوصاً جميلةً بشكل مؤلم ، فالخوف يزحف على حياتنا ، ويزحف على ألوانه القاتمة وفوق سطوح اللوحة وأعماقها. ولذا بدأتُ أنتزعها من قلب اللوحة ، أو من قلب الظلام الشبيه بالطيف المشوي، ولكنني رغم ذلك لا أتخلى عن تلك المرأة التي هي (( أمي)) فهي تعيد ترتيب خيالي وحلمي من جديد إلى عالم أكثر سعادة وبهاءاً بالرغم من حياتنا المعبدة بالوجع. فنحنُ شعبً لم نعدت الراحة ، فالقتل في تاريخنا أتت في مراحل ، فالكل حاول ردمنا في التراجيديا الحياتية. إنني أرى الموت بات يصغر ويصغر حتى الإعلان والتلفاز والجرائد وكلّ دور النشر لم تلتف لهذه القضايا إلا بشكل سطحي. أما المرأة أعجز عن حماية نفسي من جمالها فهي مغناطيسية وجاذبية لفيلسوف الـ ( أنا) وهي الخليلة والأخت والأم – ودون الغوص في الدين- الأنبياء ولدوا بين فخذي المرأة ، هذا أكبر دليل على قداستها. وهذا العالم قد أنهوا أسباب الضحك ومازلنا نصحك رغم كلّ شيء ، ولعله أنتهى سبب البكاء أيضاً لأن تكرار الألم يوماً بعد يوم نعتاد عليه ورغم ذلك مازال البكاء حاصرنا . الصراخ رمادياً في ألواني ، فالألوان المضيئة تريد الخروج من تحت الرماد من تحت الأنقاض ، من تحت الموت إنها تريد أن تخرج ، لقد حضر المستقبل المجهول لكن الأمل موجود دائماً وراء صمت العالم القذر. فهل تعود بنا الأيام نحو شمسنا الذي نألفه لنروضه ونستضيء به كما أحببناه في أحلامنا؟ نعيش في عالم ومجتمع لا يرحم المرأة ، فالجمال يدلل وهي مشروع ضحية ، وما أن نأكل مفاتنها ونحرها حتى نبدأ باضطهادها ، ربما هي طبيعة الأشياء في حاضرنا المشوه أو مشاريع الضحايا. حياتنا تحولت إلى اضحوكة العالم الفاقد رشده ، الصاعد إلى حتفه ، نحنُ مدفنون تحت نفايات الحياة ، والوحوش البشرية تجهل الآن ماذا تخسر. حرائق في كل مكان تجمع شمل الحب الذي ماغاب يوماً. عندما نعاني في داخلنا ونبكي لروح لا يعني النهاية بل معاناة وبكاء وحكمة وجمال ترفعني إلى السماء السابعة بعيداً عن كل شيء مسطح إنه يصاعدني إلى الأعماق في تلك الظلمات ، للمناخ تأثيراً على لغتي البصرية واللونية، فسابقاً كنتُ أرسم الرماد والدم ولكن الزمان والمكان صوّر لي أشياء كثيرة في المتغيرات الحياتية، فالسفر علمني فرح الزوال ، تغير الوجوه، المكان ، الزمان، اللون، وشهوات عمرنا ،و و و… الأيام سريعةً جداً لا تسمح لنا بالنظر إلى الخلف، لأن الحياة قصيرة برغم طولها وضيقة برغم فضاءها ، شائكة برغم خضارها، صحراء برغم وجود النيل والفرات ودجلة و و … ما أسرع تلك المتغيرات مضى العمر ولم نكتشف شيئاً، ربما تلك الألوان تبهر وفيها حكمة الجماد ، والموت ايضاً، لأنني أعيش على تخوم الورد في مخيلتي فقط ،وأعيش في واقعي على تخوم العدم . الأبواب كانت ضيقة للهروب من هذا الواقع المعزول وحتى الكون كله لم يكن كافياً للهروب ، الكلمات لا تكفي لإفصاح ما يجول في خاطر روحي ، ولكن الألوان كونها أقرب لي هي الكفيلة لبوح ما لا أعتبرهٍ سراً. هربنا من حصارنا من سجننا إلى حصارٍ جديد يدعى الغربة، ولهذا استعين بالألوان الرمادية لاستيقاظ الشمس لزوال الليل والموت وهاجس السفر وأفراد أحشائي، كوني الآن في جغرافية لا أنتمي إليها ولا للغتها ولكنه القدر ، وإنه التيه من الجديد. سؤال حيرني ، هل سأولد من جديد وأنزع عني كفني؟ ليس لي غير هذا العراء الصارخ في لوحاتي لأرمم ماتبقى من الروح، كل شيء يستحيل جسداً ، ( الفراغ، الأقلام، الأوراق، الألوان، غرفتي الصغيرة المؤقتة، والسرير النحيل الذي يشاركني نومي مع متاهة اله.