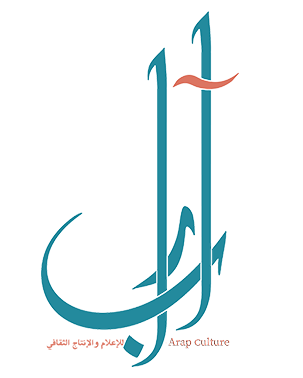إلى أبي…رسالة من تحت الماء!.
لا أزال أحتفظ بالحذاء الورديّ، وأرتديه كلّما اشتدّت بي وحدتي، ولا يزال مؤلما، ولا أزال أحتفظ بالقميص الأزرق الذي أوقعتُ عليه البيض مثل طفلة، فوضعتَ لي المنديل على ياقتي وأنا من شدّة ارتجاعي في الزّمن، كنتُ أراكَ من تحتِ الماء، أسمعك من تحتِ الماء، كم عدتُ رضيعةً وأنا ألتهم غدائي أمامك وتقع منّي اللّقمات (ارتباكا أم تماديا في الصِّغر)، كم ابتعدنا في الزّمن، أنا إلى سنواتي الأولى وأنتَ إلى سنواتكَ في الجامعة.

لا أزال أحتفظ بالحذاء الورديّ، وأرتديه كلّما اشتدّت بي وحدتي، ولا يزال مؤلما، ولا أزال أحتفظ بالقميص الأزرق الذي أوقعتُ عليه البيض مثل طفلة، فوضعتَ لي المنديل على ياقتي وأنا من شدّة ارتجاعي في الزّمن، كنتُ أراكَ من تحتِ الماء، أسمعك من تحتِ الماء، كم عدتُ رضيعةً وأنا ألتهم غدائي أمامك وتقع منّي اللّقمات (ارتباكا أم تماديا في الصِّغر)، كم ابتعدنا في الزّمن، أنا إلى سنواتي الأولى وأنتَ إلى سنواتكَ في الجامعة.
ليس السّبب في رحيلي المبكّر المجادل لمحاولاتِكَ استبقائي، لا هو الحذاء القاتل، ولا ألم رأسي وقدميّ، بل “هذاك حدّ العْشرة وهذاك ربّي ما كتب”. لمّا سألتَني عن سبب انفصالي عن زوجي وقتَها، قلتُ لكَ: “أنّي بدأتُ أكبر”، فحدّثتني عن الجدول الصّيني للعلاقات، وقلتَ لي أنّ الفرق بيننا ليس مناسبا، إذ أنا أتطوّر في الوعي بسرعة وهذا يجعلني أكبر فكريّا وعقليّا ونفسيّا عن الشّريك لهذا لا يناسبني رجل يُقاربني في السّن، لأنّه لن يفهمني. كنتُ أكتفي بالنّظر إليك، وفي داخلي رغبة موجعة في أن أخبرك بأنّي واقعة بورطة كبيرة، تردّدت كثيرا، وفي النّهاية آثرت الصّمت ظنّا منّي بأنّك ستجلِدُني بكلمة ما وأنا حسّاسة حدّ الموت، كانت روحي تستجديك: “أرجوك أنقذني”، كنتُ طوال الطّريق أقول لك داخلي، أنّني متعلّقة برجل يكبرني بعشرين عاما، هل هذا آمن لفتاة قلبها طفل وعقلها شيخ في حسابك يا بابا بشير؟ هل تعلم أنّه حظرني يوم وفاتِك؟ مع أنّه رأى مثل العالم مدى تخبّطي الذي جاهرتُ به ولا أزال…
وحده الله يعلم عن وطأة ما كنتُ فيه، وليت ذاك كان آخر سيف في قلبي، لم تتركني العَشرة سيوف حتّى شبعت التواءً فيّ، وجئتُ أسكن العاصمة لأتنّفس هواءً مختلطا بالنّبات النّابع من تربتك المحظوظة بعظامك، أملا في الشّفاء.
بابا بشير إنّه زمن صعب، الله يحبّك لأنّه لم يجعلك تراهفي المكتبة المركزيّة نهرتني الموظّفة لأنّي لم أكن أضع كِمامة، وقالت لي بينما أنا أكلّمها عن الكتاب الذي أريد إعادته: – ديريها نخاف على روحي وعليك نظرت إلى كمامتها حول رقبتِها! فوضعت الكمامة حول رقبتي، يبدو أنّها تقصد: – نخاف على خِماري وخِمارك!
لقد أصبحتُ بليدة أمام كلّ شيء، هادئة أمام غضبي أكثر ممّا يجب، وعلى أقصى تقدير أنطق بكلمات بذيئة بيني وبين نفسي… هناك قلق ما انتابني عندما اتّصل بي صديق وأخبرني أنّ رحلته إلى دولة أخرى أُلغِيت وعاد من المطار، التقيت به لأفهم منه ما حدث، فأخبرني أنّهم لم يتركوه يمرّ دون بطاقة تثبت تلقّيه للتّطعيم ضدّ فيروس كورونا، مع أنّه قبل يوم دفع الكثير من المال لإجراء فحص مقرف اسمه البي سي آر، وهناك حلّ آخر، أن يحجز في فندق فخم للحجر مدّة عشرة أيّام، مع أنّه مستأجر بيتا هناك!.
صديقي هذا طالب جامعيّ حصل على منحة دراسية في الخارج. هذا يعني أنّ مستقبلنا ليس على ما يُرام، إنّهم يريدون قهرنا واستعبادَنا، حتّى نستسلم ونضع في دمائنا ذلك الشّيء الذي سيجعلنا شامبانزيّات أو خنازير بشريّة، يقومون بقتلنا من داخلنا، أو يهيّئوننا لمستقبل السّدوميّين والميتافيرس، ولا أحد يعي الخطر المحدق بالعالم.
الشّعب بعدك صار منشغلا بالسّميد والزّيت والحليب والبطاطا، مستعدّ ذهنيّا ونفسيّا للاقتناع بأيّ شيء، مستسلم لكلّ ما تقوله الدّولة، والدّولة مستسلمة لكلّ ما يقوله العالم، مستسلم قلبًا وشحما ولحمًا ودمًا لأنّه منذ وقت طويل يعيش بلا روح.
الجهل يتسلّل هكذا، في الإنسان الذي لا قيمة في أفقه يسعى إلى تحقيقها، وهنا يعيشون لتمضي الأيّام بسلام دون أن تضرب رؤوسهم بـ “كاش مصيبة”، المهمّ أن يتخطّى الهمّ رؤوسهم إلى رؤوس أخرى غيرهم، بعقليّة الحياة المطلّة على الموت، لا أفق أمامهم غير عذاب القبر وأهوال يوم القيامة.
كيف يمكنك أن تُقنعَ القنفذ بأنّ المدى لديه ليس المدى الذي تراه الزّرافة!. بابا بشيرنظّف لي عمّي السّعيد قبرك، وثبّت باقة ورد في التّرابك، ولمّا عاد وجدني أبكي فقال لي: “بنتي كوراج”…ما زلتُ أبحث عن ذلك الأحد الذي يراكَ في كلامي موتا ملحونا راقيا، ذلك الأحد الذي أعرّي له جرحك لا ينبشه بهذه العبارة التي أكرهها: “عيشي حياتك”.
لماذا لا يفهمني أحد؟ لماذا خُلقتُ بهذا العُمق الذي جعلني أستأنس بالعُزلة والوحدة والصّمت بعيدا عن الغباء والسّطحية والتّجريح؟ لماذا ليست الحياةُ في عقلي هي الحياة التي في عقولهم؟ لماذا لم تزرني في المنام؟ في ذلك الرّابع من أكتوبر، لمّا كدتُ أن ألحق بك وأرتاحكم اشتهيتُ غفوتي في وقعتي الأخيرة على رأسي، من علوّ 182 سنتيمترا (طولي)، يااااه ما ألذّ الموتَ في الماء، هل كنتَ الذي صفعني لأفتحَ عينيّ وأسمع رنّة هاتفي من تحت الماء؟ أليست آية ربّانية أن يرنّ هاتفي في الماء، أن يبقى في جسدي إصبع يتحرّك، أن يدوس ذلك الإصبع على رقم الخيبة مرارا ولا يعرف سبيلا لغيره؟ أن أجلس لأكتب له رسالة: “أنا أحتاج إلى الإسعاف” وأقع من جديد، يُغمى عليّ ليومين دون أن يصل الإسعاف، ولا هو، ولا رسالة منه، ولا رنّة، ولو حدث ودفنوني بجانبك في مقبرة (سيدي يحيى)، كان سيأتي بعد أن تبتعد أقدام الجميع وعيونهم، ويقف على قبري قائلا: ” سامحيني يا حبيبتي لأنّي كنتُ نذلا”…
الذين نبالغ في حبّهم حتّى ونحن نموت بسببهم، لا يرون أنّ موتَنا خطأَهم. لقد كان درسا فظيعا خرجتُ منه بخلاصة مدهشة: أنا أقوى ممّا أتوقّع عن نفسي، وهذا لأنّ الله وضع بي نفسا عظيمة، بهدلُتُها بالعشق. ملأتُ صدري بهواء سيدي يحيى المنعش، أحببتُ أن يكون لي بيتٌ فيها بقربك، نستأنس ببعضنا.
سوف يأتي ما أحبّ إليّ لأنّي لطالما أهدرتُ حبّي على الأنانيّين، والغدّارين والخونة والمعقّدين والمرضى، ضحّيتُ لهم وما كنتُ أبدا اختيارهم، تركوني في حفرة العدَم أعوي “لماذا؟”، سيأتي ما أحبّ إليّ لأنّ لا شيء ممّا أحبّ متعلّق بدنياهم، بل بآخرتكم، وواثقة تماما من أنّكم أجنحةٌ تُحيطُني، فالمصائب التي خرجتُ منها لم تكن بطولتي وحدي.
أنتم كثيرون على قُدرتي في العَدِّو
إنّها سماءٌ دونَ كُسور
أرى الهَدايا تقفِزُ في الأغلفة
وهذا البياض يلعب بنُعمانِ اللّهفة
متوضِّئا ضوءَ الأصيلِ في حُقولٍ حُرّةٍ
تكبُرُ يَداها
وهيَ تَخبِزُ لِعشاءٍ أوّلٍ
يَفوحُ خِضابُها في أعماق الطّحين
فليسَ إلّا هذا المساء لنشرب في الطّين
كأسَنا الدّائمة في السّنين..
يسحرُني اتّساع بؤبؤَيكَ في قِرميد المحطّات
يَصُبُّ تاريخَهُ اللّاقِميَّ في روحي
فأرعى كطِفلةٍ بدويّةٍ خِرافَ المَسافاتِ
لَكَم يستحقُّ عطركَ طيَّها
وهو يُخشخِشُ في حَنايا التّوق…
يا لَلأرضِ
هل تحيا المَجاعاتُ في الموسيقى
وقد يأخذُني إثمُ الهوَسفي صور سائلة
تشبهها المَراعات القصيّة كشوكِ الحدَس
والبعض من أسئلةِ النّهارهضابٌ تسعى على الوهم
وتُربِكُ المَمحيّ كي يَصفو، حِبرُه للمَدى
ألم تُدرِكْ بعد؟
يا بابا إنّني حِقبةٌ جميلةٌ من الزّمن تمّ تصغيرُها في أنوثتي الكبيرة، لأعلّم العابرين بي أنّ الجينات شُعبة من شُعَبِ الخُلودِ، لا تُمنَحُ ثمنا للتّذاكر، فجنّة الله مطارُها الرّوح. أنا أميرة راسخة في الشّعبويات العتيقة، أصيلة الانفعال، وما أنتَ بغريب عن دمي ولا قلبي، للجاهلين عن عالمِ الرّوحِ والحيواتِ السّابقة حيث كنتُ بعضا منكَ حتما، ربّما أنا هنا أمّك التي فقدت قد تجسّدتُ في ابنتِكَ التي فقدَتك.. إيماني لا ريب فيه بأنّ الموتَ لن يأخذني إلّا كما أنا غير مجذوذةٍ عطاءَ اللهِ فِيّ، لكنّ خوفي ليس عليّ، بل على الإنسانيّة التي لا يُمكنني تجاهلُ عبئها على صدري، ألم أخبرك أنّ الحكمة في الجِبال وحدها؟ كلّ ما ستقابل به الله هو تراب، أيا ليتَني كنتُ تُرابًا..تقول لي: – لو كنتِ، لكان سيحِنُّ ويشتاقُ ويَسيلُ التّراب.