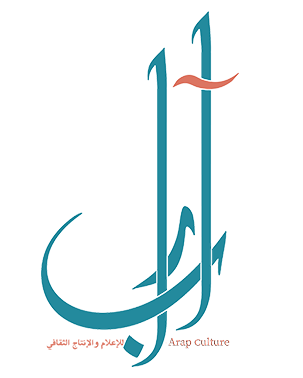تعنيف السوريات تحت مظلة القانون!
عندما نتكلَّم على مراكز حماية المعنّفات، نخرج شيئاً فشيئاً من فكرة “اللجوء الإنساني” إلى مركز ما بقصد الحماية القانونيّة والعلاج النفسيّ الاجتماعيّ، وندخل في دائرة أقرب ما تكون إلى السجون؛ حينما يختلط تطبيق النظام والانغلاق بقصد الحماية من هجوم أو أذية، بالتضييق والمراقبة والمحاسبة الأقرب إلى التسلّط من القائمين على المكان لإفراغ العقد الساديّة.

عندما نتكلَّم على مراكز حماية المعنّفات، نخرج شيئاً فشيئاً من فكرة “اللجوء الإنساني” إلى مركز ما بقصد الحماية القانونيّة والعلاج النفسيّ الاجتماعيّ، وندخل في دائرة أقرب ما تكون إلى السجون؛ حينما يختلط تطبيق النظام والانغلاق بقصد الحماية من هجوم أو أذية، بالتضييق والمراقبة والمحاسبة الأقرب إلى التسلّط من القائمين على المكان لإفراغ العقد الساديّة.
في هذه البلاد، لا ضرورة للقانون؛ أنت قادر ببساطة على شراء القائمين عليه بهدية، ببعض المال، وربّما بوجبة طعام!
بإمكانك دفن قضية قتل أو تعنيف في قسم الشرطة برشوة العميد وعناصر القسم، وبإمكانك إقناع القاضي بأنّ المدّعية أو المشتكية مريضة نفسيّاً، وأنّ آثار التعنيف البادية على وجهها، وكل جزء من جسدها المشوّه بفعل الضرب والأذية، هو مجرّد نتيجة طبيعيّة، وردّ فعلٍ طبيعيّ على رفع صوتها، أو معاندتها، أو مطالبتها بأدنى حقوقها، أو طريقة لباسها، أو ربّما لأنّها لم تحضِّر وجبة الغداء!
لست في حاجة إلى دفع أموال طائلة لتسويغ جريمتك بحقّ الأنثى في هذه البلاد. لست مضطراً إلى فعل الكثير!، يمكنك وببساطة دفع ورقة من فئة الخمسة آلاف ليرة سوريّة للشرطي؛ لكيلا يفتتح ضبطاً أو شكوى، ولا يرسله إلى القاضي العام وبالتالي ستغلق القضية كليّاً. يمكنك أيضاً شراء وجبات شاورما لعناصر القسم، ووجبة لحم محترمة للعميد مع القليل من المال، وستدفن الفتاة وقضيتها وأوجاعها دون عناء.
ليس في هذا الكلام مبالغة, وليست هذه مقدّمة أدبيّة لرواية مأساوية جديدة يتسلّى بها البعض في أوقات فراغهم, إنّ هذا الكلام هو واقع القضاء السوري، وقانونه.
أمَّا عن حال المحامين فيمكن ببساطة تغيير مجريات أي قضية إذا كان المحامي “حربوء” بالمصطلح العامِّي، ودفعتَ لهُ مبلغاً “محرز”، يمكنك تعنيف زوجتك أو اختك أو ابنتك بكامل سادّيتك ووحشيتك وستخرج من القضية “مثل الشعرة من العجين” حتى دون أن يصل الأمر إلى القاضي.
يمكنك “لفلفة” القضية، فخذ مجدك وعاود فعلتك مرة واثنتين ومئة! فأنت في مجتمع يبيح القتل والعنف تحت مسمَّى التربية، الفضيلة، الشرف، الحياد عن جادِّة الصواب….الخ. أو حتى دون مسميَّات ومسوِّغات إن شئت.
في كلِّ قضية تكون ضحيتها أنثى، توجَّه أصابع الاتهام إليها لا إلى الجاني، وإن بقيت –من سوء حظِّها- على قيد الحياة، قد تعاد ببساطة إلى بيت المعنِّف إن كان أباً أو أخاً، لكن في المرة الثانية التي تعاد فيها -ولا سيِّما إن كانت قاصراً- تعود منكسرة ومنكّسة الرأس لا صوت لها ولا قوة عندها. أمَّا إن كانت ضحية تعنيف أو اغتصابٍ زوجي، فتُردُّ إليه تحت مسمَّى “الوفاق الأسري” الذي باتت الغاية منه إذلال المرأة والاستخفاف بألمها، بإعادتها إلى بيت المعنف دون وضع رادع له أو حتى تهديده قانونياً إذا ما عاود فعلته بحقِّها؛ وكل ذلك في سبيل إرضاء رأي المجتمع والتقاليد والموروث الديني على حساب معاناتها، ولا غرابة في أنَّها ستشتهي الموت على غفلة وتدور في حلقة مفرغة من المأساة بعد أن تفقد أملها من القانون المُغيَّب أصلاً في هذه البلاد.
أمَّا بالحديث عن واقع الجمعيات النسويَّة المعدودة في سورية، والمؤسسات المعنية بمناهضة العنف ضدَّ المرأة والطفل، فليس غريباً أن يصبح الهدف من هذه الجمعيات بناء أمجاد شخصية بزيادة عدد استمارات الفتيات اللواتي يلجأن إلى الجمعية، فتُملأ الاستمارة لهنَّ بذريعة المساعدة واسترداد الحقِّ، لكن على أرض الواقع لا شيء من هذا يكون!, الأمر يتلخَّص في زيادة عدد الاستمارات المزيَّفة وبالتالي زيادة عدد وحجم المساعدات الماديَّة المُحصَّلة من الجهات الممولة أو الداعمة أو البنوك؛ وبذلك تمتلئ جيوب القائمين على الجمعية سواء كانوا حقوقيين أو رجال دين أو أطباء واختصاصيين! ومن ثَمَّ يكون تحسين صورة الجمعية وبناء أمجاد القائمين عليها ليظهروا بصورة الإنسانيين المتفانين في خدمة البشريَّة والخير على حساب أوجاع النساء ومعاناتهن التي لن تنتهي بوصولهن إلى هذه الجمعية أو تلك.
من يتأمَّل حياة البذخ والترف التي يعيشها المسؤولون عن هذه الجمعيات النسويَّة والإنسانيَّة، يدرك دون بحث أو تنقيب أنَّ هدف الجمعية بعيد كلّ البعد عن أيِّ غاية إنسانيَّة أو حقوقيَّة أو نسويَّة.
نختتم القول بجملة عابرة لأحد من استمروا لسنوات في العمل الإنسانيِّ وشهدوا وقائع تقشعرُّ لها الأبدان من الاستغلال والإساءة والإذلال: “بدك الصراحة؟ الواحد يفتح جمعية خيرية ويصنع اسم ويحصِّل تمويل ودعم، وسيقبر الفقر!”. ولا حاجة للإسهاب والإطالة، لكن يبقى السؤال مُعلَّقاً: ماذا عن حقوق الكثيرات؟ ماذا عن أوجاعهن ومأساتهن المستمرَّة والموروثة؟