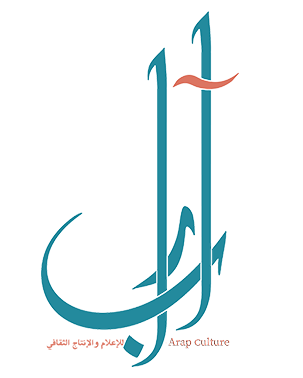لماذا نرى النقص في كل شيء؟
لقد اقترح أحد العلماء المصريين اقتراحاً جميلاً يتلخّص في قوله: “علموا الهيروغليفية للأطفال في حصّة الرسم”. ولِمَ لا؟ إذا ما كان الوقت كافياً لتعلم لغات أخرى، فما الفرق بين تعلم الإنجليزية أو الهيروغليفية أو الأمازيغية؟

سؤال تبادر إلى ذهني عند تصفّحي موقع الفيسبوك، حينما وجدت أنَّ بعضَ الأشخاص منزعجون من فكرة تدريس الهيروغليفيَّة في المدارس؛ بحجّة أنَّ تعليم القرآن أولى. وفي اعتقادي أنّه لا علاقة بينهما، ولا يتعارض تعلّم الهيروغليفيّة مع تعلّم القرآن. وحريٌ بنا أن نتذكّر أنَّ كلمة “إقرأ” حينما نزلت، إنّما شملت كل العلوم والمعارف، ولم تقتصر على علوم الدين والقرآن واللغة العربيَّة.
وكلمة “بسم الله” هي فاتحة أبواب العلوم و خزائن المعرفة. وليس مهمّاً نوع القراءة أو لغتها أو شكلها، بل المهمّ استمرار عملية القراءة كوسيلة لتحصيل المعرفة من كل صوب وفي كل وقت.
إنَّ اللغات الهيروغليفية أو الأمازيغية ضروريَّة للارتقاء بالإرث الحضاريّ الانسانيّ، ونحن أصحاب الأرض و أصحاب الرسالة.
ما أجمل أن ينشأ الأطفال وهم يدركون معنى الموروث الحضاري والزخم الثقافي الرائع الذي ورثناه، الذي سيدفعهم بدوره إلى اكتشاف المزيد مما لم نعرفه نحن. وإنّ إحياء هذه اللغات لن يلغي وجود وأهمية اللغة العربيّة؛ فالعربية بحر لجميع العلوم، والقرآن يمكن تعليمه في السنوات السبع الأولى من حياة الأطفال.
لقد اقترح أحد العلماء المصريين اقتراحاً جميلاً يتلخّص في قوله: “علموا الهيروغليفية للأطفال في حصّة الرسم”. ولِمَ لا؟ إذا ما كان الوقت كافياً لتعلم لغات أخرى، فما الفرق بين تعلم الإنجليزية أو الهيروغليفية أو الأمازيغية؟ لا فرق؛ والمهم هنا عملية تقسيم الوقت بصورة ناجعة، وفاعلية التعلم و استثمار الحياة بدلاً من اللعب غير الهادف والصخب الاجتماعي الزائف وهدر الوقت في التنافس الاجتماعي الذي يُحمِّل الفرد فوق طاقته؛ لخلق فروق في القيمة الإنسانيّة والمكانة الاجتماعيّة.
لقد درس الغرب التاريخ وأنتجوا الحضارة، لكنهم في المقابل يدركون أنهم يتطفلون على إرث غيرهم، وكلما وجدوا أصحاب هذا الإرث مغيبين، تمادوا في تطفلهم وتوسّعوا في بناء وتحقيق رسالتهم؛ فهم مؤمنون بأنّ جوهر الإنسانية يكمن في ذلك الإرث.
إنَّ الإنسان المدرك لماضيه الفاهم له، هو سيد نفسه وكونهِ وحضارته؛ فكرامة الإنسان في موروثه و قدرته على الاستفادة من هذا الموروث، ومن ترك أصله وتناسى ثقافته، فقد كل قيمته. وعلى ذلك، يكون القرآن مرشداً روحيّاً له، وهو نور الله في الأرض الذي لن يتركه أحد من ذوي العقل السليم، حتى لو تعلم آلاف اللغات؛ لأنه سينطلق من القرآن وينتهي إليه.
وفي هذه الرحلة يجب أن يفهم كل من يخوضها أنَّ الواقع الحضاري ورسالتنا التي نستمدها من ماهيتنا وخصوصيتنا وموروثنا وحضارتنا وتاريخنا؛ تلك هي القيمة الحقيقيّة، فالقرآن هو الحقيقة، واللغات والعلوم هي الواقع و على الإنسان أن يفهم الواقع و يتعلمه و يتبصر فيه؛ حتى يتسنى له أن يتلمّس الحقيقة ويعكسها على واقعه ويبقيها راسخةً في كينونته.
فمتى سنكون نحن نحن لنرى الجمال في كلِّ شيء؟