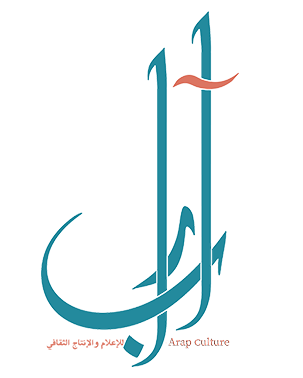كيف تحوّل الفن في سورية من عمليّةٍ إبداعيّة إلى تجارةٍ بائدة!
في الحديث عن واقع الفن والثقافة في سورية، لابدّ أن يكون السؤال الأوّل الذي يتبادر إلى الأذهان مرتبط بالوضع الاقتصادي والمعيشي للمثقّف والفنان. إنَّ محاولة التمسّك بأهداب الثقافة والانخراط في الفن، ولو في حدوده الدنيا؛ بات خارج حسابات المنطق والواقع الذي يفرض نفسه شئنا أم أبينا.

في الحديث عن واقع الفن والثقافة في سورية، لابدّ أن يكون السؤال الأوّل الذي يتبادر إلى الأذهان مرتبط بالوضع الاقتصادي والمعيشي للمثقّف والفنان. إنَّ محاولة التمسّك بأهداب الثقافة والانخراط في الفن، ولو في حدوده الدنيا؛ بات خارج حسابات المنطق والواقع الذي يفرض نفسه شئنا أم أبينا.
في حديثنا عن الفن، يصبح الكلام مقتصراً على الطبقات “المخمليّة”، أو على عمليات التصدير إلى خارج البلد. وفي ظلّ أزمات كورونا الاقتصاديّة والدوليّة، أصبحت عمليات التصدير أيضاً شبه معدومة، أو تعتمد على الطلب المحدود. إنَّ اقتناء لوحةٍ ما بمليون ليرة؛ لن يكون ضمن حسابات شعبٍ يلاحق رغيف الخبز، وهمّه الوحيد تأمين “طبخة اليوم”.
أمّا الثقافة بمفهومها المرتبط بالقراءة واقتناء الكتب أو حتى زيارة المكتبات، أصبحت شيئاً يمارسه البعض لضرورات “السوشيال ميديا” أو كنوعٍ من الترف في سبيل لفت الانتباه، أو لتعويض نقصٍ اجتماعيّ لا فكري!. ولن نخوض في متاهة الحديث عمّا فرضته التكنولوجيا الحديثة وغيّرته في عادات القراءة ورغبات القرّاء.
في حديثه لنا؛ يخبرنا صاحب معرضٍ للوحات في دمشق القديمة، تحديداً في منطقة (القشلة)، كيف تحوّل الفن من عمليّةٍ إبداعيّة إلى تجارةٍ بائدة، وكيف تحوّلت القراءة من ضرورةٍ فكريّة ودراسةٍ منهجيّة جادّة إلى مرور سطحيّ وعبثي على صفحات الكتب؛ غايتها التقاط بعض الاقتباسات. يقول: “كنّا نقرأ كتاباً حول موضوعٍ ما، ثم نتوسّع فيه تدريجيّاً، كتاباً يتلوه كتاب، وبحثاً وراء الآخر، حتى نختتم الموضوع وقد أخذنا عنه فكرة وإن لم تكن كاملة- فمعرفة الإنسان تظلّ قاصرة- لكنها فكرة عميقة وملمّة بالكثير من تفاصيل الموضوع وتفرّعاته”. ينهي العم غسّان كلامه بملامح مكفهرة، ثمّ يتابع: “لقد كان فَقْدُ سلامة البصر والقدرة على القراءة؛ أشدَّ ما ألمّ بي من مصائب خلال حياتي كلّها، ربّما لو أنني فقدت سلامة حاسّة أخرى، لكان الأمر أقل وطأةً عليّ”.

اقترحت عليه أن أحضر له بعض الكتب الصوتيّة، لعلّه بسماعها يستردُّ شيئاً من ذكريات القراءة الجميلة قبل أن تتضرر عيناه من جرّاء سقوط قذيفة أمام معرضه خلال سنوات الحرب، ويفقد بذلك سلامة البصر، وشيئاً من سمعهِ، وبعد أن شرد ذهنه قليلاً، رفض الفكرة!، وعند سؤالي عن سبب الرفض أخبرني أن ذلك يعود إلى عدم قدرته على استخدام التكنولوجيا الحديثة أوّلاً، والأهم من ذلك، أنّه لن يستطيع بهذه الطريقة تجديد متعته في قراءة الكتب الورقية والكتابة على هوامشها أو تلخيصها؛ يقول: “سأكون كمن يستمع إلى برنامج صباحيّ يبثّه الراديو، جلّ تركيزي لن يكون معه”.
وفي كلامه عن واقع وزارة الثقافة السوريّة، والمعارض الفنيّة التي تقيمها في المراكز الثقافيّة، يوضّح أنَّ المعارض فقدت الكثير من أَلَقِها؛ فالفنان في السابق ليس مثل فنان اليوم، ولم يخلُ حديث العم غسّان من الحنين إلى أيام خلت، واسترجاع شريط الذكريات الجميلة، لقد كان يرى الأمور من منظور الأصالة، وبساطة ما قبل التكنولوجيا وما قبل تيارات التجديد العبثيّة المسيئة للفن والثقافة، وربّما الإنسانيّة كلّها. فما معنى أن ترسم لوحة تضجّ بالألوان غير المتناسقة والأشكال غير المفهومة دون أن يتجاوز عمل كهذا فكرة أنّه مجرّد “تفريغ” عشوائي لضجيج يكتنف عقل الفنان ومخيّلته، دون هدف أو مغزىً. قد يكون هذه الشكل من التفريغ غاية بذاته، وهو أمرٌ يُقدَّر؛ إذ لا يُشترط في الفن أن يكون ذا غاية تخدم المجتمع بقدر ما تخدم الفنان ذاته؛ لأنَّه عمليّة إبداعيّة ذاتيّة قبل أن يكون مهنةً أو خدمة. لكن النظرة الغائية للأمور، تحتّم وجود رسالة وراء كلّ فعل إنسانيّ؛ وراء الثقافة، والفن، والعلم…الخ. وهذا تحديداً ما يجعل أحدهم يقف حائراً أمام لوحةٍ سرياليّة أو أخرى تنتمي إلى الفن التجريدي وما فوق الواقعي، ثمَّ يدير ظهره بعد ذلك يائساً من فهمها. إنّ الفنَّ توثيقٌ، وهذا ما ننتظره من اللوحات كوننا متلقّين عاديين ولسنا خبراء في الفنّ وتيّاراته ومدارسه. ومن جانب آخر نرى أنَّ ما آل إليه الفن في الوقت الحالي، ما عاد يندرج أصلاً تحت فكرة “غياب الرسالة أو الهدف”، بل بات تقهقراً وانحطاطاً، يوصف مجاملةً بأنّه فن!. كان هذا ما تبادلته من أفكار مع العم غسّان، في حديثٍ لا يخلو من النظرة المثاليّة للأمور، في معرضه الساحر تحيط بنا اللوحات والتماثيل الخشبيّة ورائحة الأصالة.