الأبطال الشعبيين في الثقافة الإسلامية
اضطهادات طائفية وهزائم عسكرية وإحساس دائم بالظلم الاجتماعي: انتج ظروف اختراع الأبطال الشعبيين في الثقافة الإسلامية!

اضطهادات طائفية وهزائم عسكرية وإحساس دائم بالظلم الاجتماعي: انتج ظروف اختراع الأبطال الشعبيين في الثقافة الإسلامية.
على العكس من الرأي السائد، والذي يذهب أصحابه إلى أن السير الشعبية تزداد وتتضخم في أجواء الرفاهية والسلام والرخاء، فأن الباحث في التاريخ الإنساني، سيكتشف أن العقل الشعبي الجمعي في مجتمع ما، لا يتوجه –في معظم الأحيان- نحو اختلاق الشخصيات البطولية وتضخيم أدوارها، إلا مع الإحساس بالخطر، أو الشعور بالظلم والجور والاضطهاد، بما يعني أن الشعور المزمن بالمعاناة والألم، هو الذي يمثل الرافد الرئيس الذي تستمد منه الشخصيات البطولية الشعبية، زخمها وحضورها المؤثر في العقل الجمعي.
من هنا، يمكن القول إن أجواء الهزائم العسكرية الساحقة، وعصور الاضطهاد الديني والمذهبي، كانت بمثابة أوساط ثقافية ممتازة، مناسبة لانتاج مجموعة من الأبطال الشعبيين، من أصحاب الكرامات والمعجزات، والذين لعبت شخصياتهم أدواراً مهمة في توجيه الشعوب والتعبير عما يحيق بهم من أزمات ومشاعر مكبوتة.
سمعان الخراز ونقل جبل المقطم: كيف تفاعل الأقباط مع الاضطهاد الطائفي؟
رغم أن العصر الفاطمي قد شهد تسامحاً وانفتاحاً ملحوظين مع الأقباط المصريين، للدرجة التي أسهمت في تحول الكثير من المسيحيين المصريين إلى الإسلام، في القرنين الرابع والخامس الهجريين، إلا أن بعض فترات ذلك العصر قد صادفت وقوع بعض أحداث الاضطهاد الطائفي الذي لا يمكن إنكاره.
الثقافة القبطية الشعبية، تفاعلت بشكل إيجابي مع تلك الأحداث، إذ عملت على الدفاع عن ذاكرتها المقدسة من خلال اختلاق بعض المواقف الإعجازية التي تناقلتها عدد من المصادر الدينية، ومن أشهر تلك المواقف ما أورده الكاتب القبطي ساويرس بن المقفع في كتابه “تاريخ البطاركة”، والذي ذكر فيه أن الوزير يعقوب بن كلس، وكان يهودي تحول لاعتناق الإسلام، قد رغب في الإيقاع بالمسيحيين المصريين عند الخليفة الفاطمي المعز لدين الله.
بحسب ما ورد في الكتاب، فأن ابن كلس قد استعان ببعض رجال الدين اليهودي وطلب عقد مناظرة مع بطريرك الأقباط أمام الخليفة، فلما وقع ذلك، ظهر تفوق البطريرك على خصومه، فدخل الوزير على الخليفة ذات يوم وقال له “إن مولانا يعلم إن النصارى ليسوا على شيء، وهذا إنجيلهم يقول: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، لكنتم تقولون لهذا الجبل، انتقل من هنا إلى هناك فينتقل”، وطلب الوزير من الخليفة أن يستدعي البطريرك لينقل جبل المقطم لإثبات صدق ما ورد في الإنجيل وصدق إيمان القبط.
بحسب رواية ابن المقفع، والذي كان شاهد عيان على تلك الأحداث، فأن البطريرك قد جمع الرهبان والأساقفة ومكثوا صائمين لمدة ثلاثة أيام في الكنيسة المعلقة، وفي اليوم الثالث ظهرت لهم العذراء مريم، وأخبرتهم عن إنسان قديس اسمه سمعان الخراز، وأنه الشخص الذي ستجري معجزة نقل الجبل على يديه.
بحسب الروايات القبطية، فأن سمعان والرهبان بدأوا في تلاوة بعض الصلوات، فارتفع الجبل وانتقل من مكانه القديم في بركة الفيل بالسيدة زينب، إلى مكانه الجديد، أمام أعين الخليفة الذاهلة، والذي لم يسعه إلا أن يعترف بقدرة المسيح، وأن يتحول من فوره إلى الدين المسيحي، كما استجاب لطلب البطريرك فأعاد بناء كنيسة أبي سيفين بمصر القديمة.
وإمعاناً في أسطرة القصة، فأن الرواية تتحدث عن اختفاء القديس سمعان الخراز بعد أن أتم عمله ونقل الجبل، وظل جثمانه مختفياً على مر القرون، حتى تم الاعلان عن العثور على جثمانه في عام 1991م، وذلك في كنيسة العذراء بمصر القديمة، وذلك في واحدة من المعجزات التي تواكبت -هي الأخرى- مع الإحساس القبطي الجمعي بالاضطهاد والتهميش في العصر الحديث.
رولان وفلورا: الأبطال الشعبيين في الأندلس
إذا كانت الهزائم العسكرية والضوائق الاقتصادية، كانت العوامل الأكثر بروزاً وحضوراً في تشكيل السير الشعبية للأبطال في الكثير من البلاد الإسلامية، فأن الأندلس وإن لم تمثل استثناء عن تلك القاعدة، إلا أن ثقافتها الشعبية قد ارتبطت أيضاً بظروف الاختلاف والتنافس الديني الإسلامي- المسيحي، تلك التي ظلت قائمة على مدار ما يزيد عن القرون الثمانية. من هنا، نستطيع أن نميز عدداً من النماذج المهمة للبطل الشعبي في الثقافة الأندلسية، ومنها رولان، والقديسة فلورا.
فيما يخص القائد الفرنجي رولان، فأن قصته تعود لعام 157ه/ 773م، وذلك عندما اتفق والي سرقسطة الحسين بن يحيى الأنصاري، مع حاكم برشلونة سليمان بن يقظان الكلبي، على الثورة على الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل، واتفق الاثنان على التحالف مع ملك الفرنجة شارلمان.
بحسب ما يذكر محمد عبد الله عنان في كتابه “دولة الإسلام في الأندلس”، فأن شارلمان تحرك بجيوشه إلى الأندلس، وهاجم بلاد البشكنش في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية، ولكنه أضطر إلى العودة بسرعة إلى فرنسا عندما عرف بتمرد قبائل السكسون، في الوقت نفسه، الذي تعرضت فيه مؤخرة جيشه، تلك التي يقودها رولان، لهجوم مفاجئ من قبل البشكنش أو المسلمين.
رولان تم تخليده في الذاكرة الشعبية المسيحية الفرنجية، إذ نُسجت قصة مؤثرة عنه، تصوره في صورة البطل الذي يرفض الانسحاب من بلاد الأندلس، وأنه كان يلح على شارلمان بالبقاء لإنقاذ البلاد من الحكم الإسلامي، غير أن أحد مساعدي الملك، وتعرفه الملحمة باسم جانلون، كان قد استطاع أن يقنع شارلمان بالرحيل، ولأنه كان يحقد على البطل رولان، فأنه سعى في تعيينه على قيادة مؤخرة الجيش، كما اتفق مع المسلمين على الإحاطة به وقتله.
الملحمة تذكر أن رولان قد أصر على القتال حتى النهاية، كما أنه رفض أن ينفخ في بوقه طالباً مساعدة القوات الفرنجية الأمامية، وظل على أرض المعركة حتى قُتل مع كل جنده.
أنشودة رولان تحولت من الصيغة الشفاهية إلى الصيغة المكتوبة في القرن الحادي عشر الميلادي، وتواكب ذلك مع الدعوة للحروب الصليبية، إذ صار رولان ملهماً للمقاتلين والفرسان الصليبيين الذاهبين للقتال في بلاد الشام.
النموذج الثاني، يرجع إلى ثلاثينيات القرن الثالث الهجري، عندما عُرفت في قرطبة ظاهرة سب الدين الإسلامي والنبي محمد، بين العديد من مسيحيين الأندلس.
ترجع أصول تلك الظاهرة إلى فتاة تدعى فلورا، وهي ابنة لأب مسلم وأم مسيحية، ولما مات أبوها، تحولت فلورا إلى المسيحية، ورفضت الرجوع إلى الإسلام، وتحملت اضطهاد أخيها المسلم الذي التمس العديد من الوسائل لإجبارها على الإيمان بالدين الإسلامي.
بحسب ما يذكر ستانلي لين بول في كتابه “قصة الإسلام في الأندلس”، فأن فلورا لما عُرضت على القاضي المسلم، رفضت الرجوع للإسلام، وأصرت على موقفها، حتى تم إصدار الحكم بإعدامها، وتم تنفيذه في 237ه/ 851م.
موقف فلورا تم تكريسه في الثقافة الشعبية المسيحية في الأندلس، على كونه نوعاً من المقاومة للحكم الإسلامي، ومن هنا فقد سار الكثير من المسيحيين المتعصبين على خطاها، واندفعوا للإعلان عن رأيهم السلبي في الدين الإسلامي ورموزه، خصوصاً بعدما تم تشجيعهم على ذلك التوجه من قبل قس مسيحي معروف يدعى أولوخيو.
وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة المتطرفة قد تم القضاء عليها في وقت قصير، إلا أن ذكرى فلورا قد ظلت حاضرة في الوجدان المسيحي، وتنامت فيما بعد مع حروب الاسترداد المسيحية ضد المسلمين، إلى الحد الذي دعا الكنيسة الكاثوليكية لترسيمها كقديسة وشهيدة فيما بعد.
عثمان بن الحبلى: كيف عبرت السيرة الشعبية عن احساس المصريين بظلم المماليك؟
تتفق المصادر التاريخية على عرض صورة بائسة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تلك التي عانت منها الطبقة العريضة من العوام المصريين أثناء العصر المملوكي.
المماليك، الذين ابتدأ أمرهم في الدولة الأيوبية، كمجموعات من العبيد الأرقاء، المجلوبين من بلاد الترك والشركس، والذين تمت تربيتهم وتنشئتهم على أسس عسكرية منضبطة، وصلوا إلى حكم البلاد في أواسط القرن السابع الهجري، وانتهجوا سياسة عنيفة باطشة مع عموم المصريين.
الضغط الذي وقع على أهل البلاد، واحساسهم المتزايد بالظلم والجور الذين تعرضوا له، دفعهم دفعاً لاختلاق سير شعبية أسطورية الطابع، بحيث يظهر فيها المصريون وكأنهم أصحاب السلطة الحقيقية في البلاد، وإن قوتهم توازي قوة السلطة المملوكية، إن لم تتفوق عليها وتعلوها في الكثير من الأحيان.
في هذا السياق، من الممكن أن نستشهد بنموذج مهم، وهو عثمان بن الحبلى، وهو شخصية مختلقة، لم تظهر على مسرح الأحداث التاريخية. يظهر عثمان في السيرة الشعبية المعروفة للظاهر بيبرس، على كونه واحداً من العيارين الشطار، الذين اشتهر أسمهم في الديار المصرية، وأن الدولة قد عجزت عن القبض عليه لشجاعته ومهارته في الهروب والتخفي.
بحسب السيرة الشائعة، فأن بيبرس قد بذل مجهوداً عظيماً في سبيل القبض على عثمان، وكاد أن يدفع حياته ثمناً لتحقيق هذا الهدف، ولما وصل إليه، رأى السيدة نفيسة في المنام، وقالت له “هذا تابعي وخديمي وأنا لم أفوته أبداً، ولكن رضيت أن يكون خديمك على طول المدى ويكون سامعاً مطيعاً، وكذلك أنت الأخر تطيع أمره…”.
من هنا فأن السيرة تؤكد على أن الرجلين، بيبرس وعثمان، قد صارا صديقين وحليفين، وأن الثاني قد صار المعادل الشعبي للبطولة، كما أصبح قسيم أساس في السلطة ومشارك لا غنى عنه في أمور الحكم. وفي هذا السياق، يذكر الدكتور إبراهيم عبد العليم حنفي في كتابه” البنية الأسطورية في سيرة الظاهر بيبرس”، خصوصية ورمزية ابن الحبلى في السردية الشعبية المصرية، إذ يقول “أظهرت السيرة عثمان بن الحبلى نموذجاً للبطل الشعبي ابن البلد، وجعلت منه حياة اللصوصية التي يعتليها، ويمسك بلجامها جيداً وسيلة بتمرده الاجتماعي والسياسي، فكان يمثل نسقاً اجتماعياً فريداً…”.
طومان باي: المتولي، شيال الحمول، الذي تسبب الظلم العثماني في تشكيل سيرته
استمرت المُخيلة الشعبية المصرية في اصطناع أبطالها في العصر العثماني، والذي بدأ مع دخول السلطان سليم الأول، لمصر في عام 1517م. الثقافة الشعبية المصرية اهتمت في تلك المرحلة بسير الشطارين والعيارين وأهل الفتوة، كما سلطت الضوء أيضاً على بعض رجال السلطة والحكم.
الكتابات التاريخية التي تناولت عصر المماليك، اتفقت على أن طومان باي، أخر السلاطين المماليك على مصر، قد اختلف كثيراً عن أسلافه من السلاطين المتعجرفين الظلمة، الذين لم ينشغلوا إلا بفرض الضرائب والمكوس، ومن هنا فقد كان اعدام طومان باي على مرأى ومسمع من العامة في 21 ربيع الأول 922ه/ 15 سبتمبر 1517م، ذا أثر بعيد في نفوس المصريين، إلى الحد الذي دفعهم دفعاً لوضعه داخل حيز الأبطال الشعبيين المُتخيلين.
يمكن القول بأن اللحظة التاريخية الصعبة التي تواكبت مع اعدام طومان باي، كانت هي السبب الرئيس في فتح الباب أمام دخول شخصية طومان باي إلى حيز البطولة الشعبية، إذ أن مصر فقدت في تلك اللحظة، مركزيتها ومكانتها في محيطها الإسلامي، وأضحت مجرد ولاية تابعة لسلاطين آل عثمان، بعدما حافظت على هيمنتها وعلو مقامها، لما يزيد عن القرنين من الزمان.
يتوافق هذا، مع درامية ومأسوية لحظة اعدام طومان باي، إذ يتحدث ابن إياس عن تلك اللحظة، فيذكر أن السلطان المملوكي قد طلب من الجماهير الملتفة من حوله أن يقرأوا له الفاتحة لثلاث مرات، ثم صعد إلى المشنقة بثبات دون خوف، غير أن حبل المشنقة قد انقطع به لثلاث مرات متكررة، فيما فهمه المصريون على كونه إشارة روحية عميقة تثبت بطولة هذا السلطان.
ابن إياس، يذكر أن المصريين قد أظهروا حزنهم على السلطان المملوكي الأخير، بمجرد أن فارق الحياة “فلما شُنق وطلعت روحه، صرخت عليه الناس صرخة عظيمة، وكثر عليه الحزن والأسف…”، وفي السياق نفسه، يؤكد ابن زنبل الرمال في كتابه “أخرة المماليك” “وكان ذلك اليوم –يوم مقتل طومان باي- على أهل المملكة، أشأم الأيام، وبكت عليه الأرامل والأيتام”.
ومن الجوانب المُتخيلة التي أضيفت لشخصية طومان باي في الثقافة الشعبية المصرية، أن العوام من المصريين قد سموه باسم المتولي، وسموا باب زويلة باسم بوابة المتولي، ربما للتحايل على السلطة العثمانية التي كانت تمنع من ذكر اسمه، بحسب ما يذكر الدكتور عبد المنعم ماجد في كتابه “طومان باي أخر سلاطين المماليك في مصر”، وقد صور هذا المتولي في الثقافة الشعبية، على كونه شيخاً صوفياً صاحب كرامات ومعجزات، ومنها القول الشعبي الشائع “يا شيال الحمول يا متولي”، والذي يعبر عن قدرة هذا المتولي على مساعدة العجزة والمساكين والمحتاجين والضعفاء في كل زمان ومكان.
بطال غازي: هزيمة أكرونيون التي تسببت في تشكيل أهم السير الشعبية التركية
تتحدث الكثير من المصادر التاريخية الإسلامية، ومنها على سبيل المثال، “تاريخ دمشق” لابن عساكر، و”سير أعلام النبلاء” لشمس الدين الذهبي، و”البداية والنهاية” لابن كثير، عن شخصية القائد المسلم عبد الله البطال، والذي لعب دوراً مهماً في حركة التوسع الأموي في الأناضول وأسيا الصغرى في القرن الثاني الهجري، إذ شارك في حصار القسطنطينية الشهير في عام 98ه، وحاصر بعدها مدينة نيقية، كما ظهر أسمه في فتح مدينة خنجرة الواقعة في شمال شرق أنقرة.
مع ذلك، كانت نهاية البطال، مؤسفة إلى حج بعيد، إذ قُتل في ميدان معركة أكرونيون في 122ه، مع عدة آلاف من المسلمين، في واحدة من أهم وأشهر الهزائم والانتكاسات الحربية في تاريخ دولة الخلافة.
تلك الهزيمة الساحقة، تضافرت مع أخبار التاريخ العسكري المجيد للبطال، في سبيل تكوين وتشكيل سيرة شعبية أسطورية لذلك المقاتل المسلم العتيد، وذلك عندما استعان الأتراك بشخصيته بعد عدة قرون، فصبغوه بالصبغة التركمانية، إذ صار اسمه هو بطال غازي، وتم الترويج لكونه ينحدر من نسل الإمام علي بن أبي طالب، وأنه قد مُنح قدرة خارقة في القتال وفنون الحرب والتسلل إلى قلاع الأعداء، هذا فضلاً عن إجادته “لواحد وسبعين لغة ولسان”، ومقدرته على اقناع أسراه من البيزنطيين بالإسلام.
وبحسب ما يذكر شوقي عبد الحكيم في كتابه “الأميرة ذات الهمة”، فأن صيت البطال قد علا في الأناضول والبلقان، حتى أعتاد الأوروبيون على إخافة أطفالهم بذكر اسمه، فيقولون “اسكت يا صبي، وإلا أحضر لك البطال”.
وبحسب المصدر ذاته، فأن الشخصية الأسطورية للبطال، قد لعبت دوراً مهماً في إلهام مجموعة من السلاطين المسلمين، ومنهم صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس، كما أن محمد الفاتح قد استند إلى تلك الشخصية في سبيل إضفاء الشرعية السياسية والدينية إبان فترة حصاره لمدينة القسطنطينية “إذ روج لنفسه باعتباره حفيد بطال غازي”.
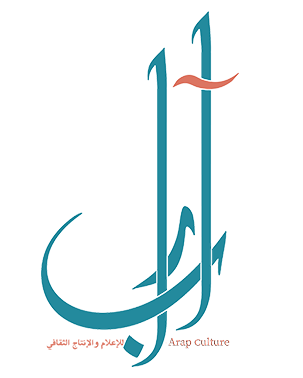

مقالة رائعة د. محمد يسري.
جزاك الله خير على هذا المجهود المعرفي
د. محمد الزّكري