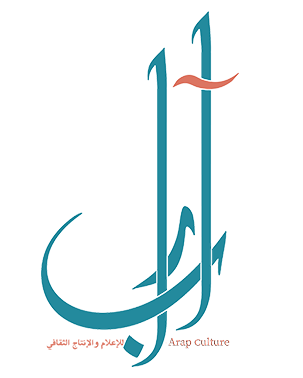أنساق التجربة الجمالية، وأبعاد الهوية البصرية في تجربة الفنان العراقي فائق العبودي
ينتمي الفنان العراقي فائق العبودي إلى تربة الفن الأصيل الحامل للهوية العراقية، وهو الدارس للفنون الجميلة والتصوير الفوتوعرافي، وللتصميم. تابع دراسته العلمية للتصميم الطباعي في سويسرا، فضلا عن حصوله على بكالوريوس فنون من الجامعة العربية المفتوحة في شمال أمريكا . اتخذ الفنان فائق العبودي من مدينة لوزان السويسرية

ينتمي الفنان العراقي فائق العبودي إلى تربة الفن الأصيل الحامل للهوية العراقية، وهو الدارس للفنون الجميلة والتصوير الفوتوعرافي، وللتصميم. تابع دراسته العلمية للتصميم الطباعي في سويسرا، فضلا عن حصوله على بكالوريوس فنون من الجامعة العربية المفتوحة في شمال أمريكا . اتخذ الفنان فائق العبودي من مدينة لوزان السويسرية منذ عام 1999 مستقرا له، وأسس فيها مركز فضاء الشرق الثقافي، ومجلة ألوان الثقافية وهي مجلة تهتم بالثقافة والإبداع والفنون.
شارك في عدة معارض رفيعة ببغداد وعديد العواصم العربية والغربية، ونال قدرا كبيرا من الإشادة النقدية بتجربته الفنية التشكيلية مما أهله لعضوية أكاديميات فنية مختلفة نذكر منها: جمعية الفنانيين التشكيلين العراقيين، جمعية الخطاطيين العراقيين، الرابطة الدولية للفنون باريس. ورغبة في الاقتراب من متخيله الفني المتسم بالفاعلية والتكثيف، وفي فهم البنيات الدلالية لمنجزه التشكيلي، ورصد ملامح الهوية البصرية لتجربته الفنية الرفيعة كان لنا معه الحوار التالي:
تراهن في تجربتك الفنية على استثمار الذاكرة، وتوظيف طاقتها الجمالية في ممارستك التشكيلية، وهو ما جعل الناقدة السويسرية لورانس فولكنر سيبوز تصفك بقولها:” إذا كان فولتير قد اعتبر أن الكتابة هي صوت الكلام، فإن العبودي برسمه لحروف الكتابة القديمة أعطاها حقها في الصوت والكلام”. كيف تنظر إلى هذه الرؤية النقدية، وكيف تمتلك أعمالك الفنية صوتها الخاص؟
سعدت جداً يوم قرأت الدراسة النقدية التي قدمتها السيدة الناقدة لورانس، وهي تضع اسمي مع أسماء شامخة في الفلسفة مثل الفيلسوف الفرنسي فولتير. بيد أن الحظ ، أو الفرصة كان وراء تقديمي لمعرضين شخصين في بيت هذا الفيلسوف العظيم، حيث اتخذت مدينة فولتير الفرنسية بيت الفيلسوف مركزاً ثقافياً وسياحياً هاماً. في منظوري فاللوحة عبارة عن باقة من المشاعر والأحاسيس يعيشها الفنان في صيغة الحاضر أو الماضي.

في الحاضر حيث تتمثل في الأفكار التي تتكون من خلال المشاهدات اليومية للفنان، وفي الماضي ارتباطا بما هو مخزن في الذاكرة، وجمع فيه كل المؤثرات التي مرت في حياته، من مرحلة الطفولة بلهوها وفرحها، ومرحلة الشباب فرحها وحزنها والحرمان والأماني والمشاهدات اليومية والصور التي كونتها حكايات وقصص الأجداد أو الأمهات، أو من خلال أحلام عالقة في الذاكرة لا يمكن نسيانها.
وبموجب ذلك فالفنان ينهل من هذا المخزون الكبير لعمله الفني. ولوحاته هي ترجمة للأحاسيس والمشاعر والصور والانفعالات. بل لعوامل أخرى مثل الموسيقى بنوتاتها وإيقاعها، في النحت والسيراميك من خلال الطين، وفي الأدب من خلال الكلمات والصور، وفي الرسم بالألوان. اللون هنا بمثابة النوتة في الموسيقى، يوظفها الفنان للتعبير عن الحالة التي يود طرحها. وللألوان رموز ودلالات، اللون هو صيغة مركبة فضلا عن مدلولاته المألوفة لأنه يعبر عن حالة نفسية معينة الأسود مثلا يعبر عن الحزن أو الاكتئاب، والأبيض يعبر عن الطهر والنقاء، والأخضر عن الخير والعطاء، وهكذا بقية الألوان لها دلالاتها ومعانيها. والفنان يوظف هذه الألوان بدقة وعناية لتتناسب مع مشروعه الفني، وهو يعزف سيمفونية الألوان على إيقاع ضربات الفُرشات. ولعل ذلك هو الصوت الذي وضعته في حروف الكتابة القديمة .
هذه الرؤية تكشف تعدد مرجعياتك الفنية والجمالية، وهذا ملمح انتبهت إليه الناقدة السويسرية لورانس فولكنر، بوصفك كفاعلا عراقيا في المشهد التشكيلي السويسري، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
ارتباطا بسياق السؤال يمكن القول أني استثمرت فرصة وجودي هنا ارتباطا بجهدي الفني وطبيعة الاشتغال والمنظور الجمالي لتجربتي التشكيلية، وارتباطا بالتقاليد المرافقة للمعارض التشكيلية فإن ما كتبته الناقدة السويسرية كان متابعة نقدية لمعرض شخصي قدمته في مدينة فرني السويسرية التابعة لمدينة جنيف، وعند زيارتها للمعرض اقتنت عمليين فنيين تقديرا منها لتجربتي التي نالت اهتمامها. أعمالي نالت إعجاب عدد كبير من المتذوقين والمقتنين. هذا الاهتمام جعل الإعلاميين والنقاد يهتمون بتجربتي ويكتبون عنها ويقدمونها في منابر مختلفة سواء في الصحف والمجلات الفنية والإذاعة والتلفزيون، وبموجب هذا الاحتفاء النقدي والاهتمام الإعلامي بتجربتي التشكيلية تمت دعوتي مرارا لتقديم تجربتي في عدد من دور الفن المرموقة.تشكل المعارض الفنية فرصة لكشف الطاقات التشكيلية، ورصد طبيعة الممارسة التعبيرية فنيا وجماليا، هل كان للمعارض التي أقمتها في سويسرا وغيرها من الدول الأوربية هذا الدور في تجربتك الفنية؟
غادرت العراق عام 1997 وكان في رصيدي معرض شخصي واحد مع مشاركات جماعية عديدة، و قدمت معرضي الشخصي الثاني في الشارقة عام ،1998 في جمعية الفنانيين التشكيلين الإماراتيين، واليوم بفضل الله في رصيدي سبعة وعشرون معرضاً شخصياً، وعشرات المشاركات العالمية، ولوحاتي توزع في مختلف دول العالم ، فضلا عن جداريتي في مدينة فرني التابعة لمدينة جنيف.
هل ينظر إلى تجربتك الفنية كفنان عربي في بلاد المهجر، أو ما يمكن تسميته بالفن المهاجر؟
الجميل والمريح جداً هنا أن الناس لا يفرقون بين عربي أو أوروبي أو إفريقي، طالما أن الإنسان يحترم القوانين، ويحترم البلد الذي يعيش فيه، ويراعي فن العيش المشترك. هوية الفن لا ترتبط بالعرق أو بالهويات القومية فقط، فالمشترك الجمالي والإنساني في تقديري له أهميته الخاصة، الفن ينتمي إلى كل الناس. إن الأمر بشكل دقيق يعتمد على ما يقدمه الفنان، إذا كان جديداً وحداثيا، وفيه من الخصوصية التي تثير الاهتمام يلقى ترحيبا واهتماما، ولا ينبغي أن ننسى أن الناس هنا لديهم ذائقة فنية مذهلة وعلى درجة عالية من الخبرة الجمالية. لذلك من الصعب إقناعهم بالعمل المألوف أو المتواضع. وقد وجدت شخصياً اهتماماً رائعاً، ربما أيضاً خدمني الموضوع الذي أشتغل عليه: التاريخ القديم. إن المشاهد أو المتذوق هنا مثقف، وله معرفة كاملة بتاريخ بلاد ما بين النهرين ، لذلك لا يجد صعوبة في قراءة اللوحة في كل مكوناتها الجمالية.
كيف يمكنك تحقيق مزية تمتين العلاقة الإبداعية مع المشاعر في فضاء اللوحة، وهل تشكل هذه المزية عامل نجاح في عملك الفني؟
حب العمل والصدق والإخلاص أساس مهم لإيصال المشاعر والأحاسيس في فضاء اللوحة وداخلها. وينطبق ذلك على كل عمل في مجالات الحياة. بيد أن النجاح والفشل يعتمد على عاملين، الأول في تصوري الحظ، والثاني أنه على الفنان أن يفهم جيدا أن الساحة الفنية مليئة بالمبدعين، بتجاربهم الإبداعية المميزة والرصينة. الساحة الفنية الكبيرة وهي بمثابة حقل ألغام على الفنان أن يجتاز ذلك الحقل بنجاح ليصل لهدفه المنشود. المطلوب المثابرة والتواصل، والبحث، والتجريب، والممارسة لكسب الخبرات، و لو توفرت الخبرات يستطيع الفنان السباحة في عمق هذه الساحة. والرهان على النجاح يتطلب التعب ومحاولات عديدة، وعدم الخوف أو التردد.
كشفت العوامل المساهمة في تشكيل اللوحة، لكن هل المتلقي قادر على رصد هذه الطاقة الكبيرة من الحدس في لوحاتك الفنية، وفك شفراتها؟
حسب وجهة نظري فإن تفكيك الشفرة ( (Cipherمسؤولية المشاهد، من خلال التذوق الفني الذي يحتاج إلى تدريب الحواس؛ وخاصة اللمس والبصر والسمع. و هذا التدريب يأتي من الوعي الجمالي الذي يمكن الفرد من التعرف على تاريخ الفنون والمدارس الفنية المختلفة، ومن خلال زيارة المتاحف والمعارض، والتعرف على قيمها الجمالية، كذلك التأمل في جمال الطبيعة. تحضرني قصتان جواباً على سؤالك: الأولى حدثت في الإمارات، حيث دعوت صديق إلى معرضي الشخصي، وبعد أن جال في المعرض متفحصاً كل اللوحات، اتجه إلي قائلاً:”ما هذه الخرابيط”. أما الثانية فقد زارت امرأة سويسرية مسيحية مشغلي في سويسرا، وتوقفت عند إحدى لوحاتي لوقت طويل، ثم جاءت بعدها بأيام، وتوقفت عند اللوحة ذاتها، وسألتني عما في تلك اللوحة، فأجبتها شارحاً التكنيك الذي استخدمته فيها، فأجابت بأنها ترى نوراً في تلك اللوحة يلامس روحها، أصبتُ بالدهشة، فقد ضمنت اللوحة اسماً من أسماء الله الحسنى: وهو:”الرحمن”، فشرحت لها أنني مسلم، وأن ما في اللوحة اسم من أسماء الله الحسنى، فاقتنتها في اليوم ذاته.
هل أنت مع قيام الفنان بشرح فكرة عمله أو لوحته أمام الجمهور وإظهار ما خفي عن المتلقي ؟
أنا ضد فكرة تسمية اللوحة أولاً، لسبب بسيط جداً؛ لا أريد أن أضع المشاهد في خانة أنا أقترحها عليه باختياري للعنوان الخاص للوحة. أريده أن يكون حراً طليقاً يسميها كما يشاء، وكما يشعر بها، أعتقد مسؤولية الفنان تنتهي حال وضع توقيعه. اللوحة مجموعة من الأحاسيس يصعب تفسير أو شرح الإحساس، وبحسب النظريات والعلوم المختلفة، النظرية البنائية على سبيل المثال تعرف الإحساس على أنه أمر غير قابل للتحليل والتفسير، بل للإدراك فقط . وبإمكان الفنان شرح فكرة الموضوع مثلاً، تقنية العمل، الخامة المستخدمة، وهكذا.
ماهي طبيعة المكونات التقنية والأسلوبية أعمالك التشكيلية؟
اللوحة قبل أن تكون حصاناً أو طائراً، هي عبارة عن انفعالات وأحاسيس تترجم من خلال اللون، والضوء والخطوط عناصر مهمة جداً باللوحة. واللوحة دون تلك العناصر فارغة، وتفتقد للكثير من طاقتها التعبيرية. ينبغي على الفنان أن يكون الفنان على دراية ومعرفة تامة بمشروعه الذي يقدمه أو ينوي تقديمه. تحضرني – في هذا السياق- مقولة للفيلسوف الفرنسي ألبير كامو يقول ( لدى الفن عدو اسمه الجهل) وهذا ينطبق على الفنان والمشاهد. في عملي أتجاوز كثيراً عناصر الضوء والخطوط، أعتقد أنني أرسم أشياء أكثر تعقيداً بالنسبة لي؛ في محاولة لتحدي الحدس الخلاق في داخلي. كنت صغيراً أزور المتحف العراقي للتاريخ القديم، وأتسمر أمام الأعمال الفريدة، وكأني أدرسها دراسة، وأرجع إلى البيت أحاول تقليدها بالطين. نعم لقد جئت من خلفية تقدر هذا النوع من الأعمال بل وأقدسها. وهذه الأعمال لا تزال إلى اليوم تسبح في ذهني، وأود أن أقدمها بشكل يليق بها. حديثي وإنشدادي إلى الماضي هو حديث مع الحاضر أيضاً. بالنسبة لي الفن يزيل المسافة ويزيل الوقت أيضاً، كأنه سحر، والأجمل هي القدرة الفنية على الجمع بين الماضي والحاضر.
لماذا تميل إلى استخدام الألوان ذات الإضاءة القوية في منجزك التشكيلي؟
ربما للبيئة تأثير قوي على هذا الموضوع، لكوني قادم من بلاد الشمس، ولشمس بلادي في داخلي نور لا ينطفئ. والسبب الآخر أن الألوان ذات الإضاءة القوية تمتلك طاقة دلالية، وتسعفني في ترجمة ممكناتي الفنية وتجسيدها عبر الحركة اللونية والضوء والرهان على تكثيف المعنى واستثمار الرمز التاريخي وتطويعه ليصبح رمزا فنيا حاملا لطاقة جمالية مخصوصة. إن الأمر لايرتبط بالحدس فقط بل بتساوق نوعي يربط بين الحدس وبين التأمل بحثا عن الدهشة الجمالية. ومن طرائق الاشتغال فإني في بداية رسم كل لوحة لا أتمكن من رسمها دون استخدام اللون الأحمر، حتى ولو بنسبة محدودة تنسجم مع جو اللوحة، يتسلل إلي ذلك اللون خلسة، ليكون بمثابة أمل مشرق يمتد إلى فضاء اللوحة الفسيح.
تاريخ وحضارة العراق تشكل مرجعية متجددة في منجزك الفني، لكنه لا يتواجد بأنماطه الجمالية المتوارثة بل تبعا لرؤيتك الجمالية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
تاريخ العراق عظيم، وحضارته تمتد لآلاف السنين، هذا التاريخ كنز لا ينضب، ثري وقوي ومؤثر. و لا توجد لدي لوحة واحدة لم استلهم فكرتها من تاريخ العراق القديم، اشتغل اليوم على الرموز القديمة والتمائم السومرية أقدمها بفخر، وأشعر كأن روحاً سومرية تلبست جسدي، وربطتني بذلك الماضي السحيق لتملأ ذاكرتي بخزائن من الرقم الطينية، صنعها أجدادي السومريين و دفنوها لتكون شاهداً عليهم. و أنا أعيد صناعتها مازجاً القديم بالحديث والماضي بالحاضر، لتكون شاهداً على الوفاء لذلك الإرث العظيم. سنوات الغياب تجعلني مشدوداً أكثر إلى هذا التاريخ العريق.
كيف يمكنك الانتقال من المادي المحسوس إلى التجريدي إلى وتحويل هذه المرجعيات الرمزية إلى فن تشكيلي وجمالي؟
القلق هو زادي الأول، ربما هو طبعي، لذلك التجريب بالنسبة لي هو نوع من المورفين الذي من خلاله أصل إلى خيالات وأفكار جديدة لمشاريعي المستقبلية. وكل عمل أقدمه يرى فيه المشاهد تقنية خاصة جداً، وتفاصيل كثيرة، أجعله يسبح فيها متأملاً التفاصيل التي تدل على حجم أو كمية ساعات العمل الوسواسي لكي أنجز عملي الفني في ميسمه الجمالي.
ما هي أبرز التقنيات التي تفضل استخدامها في لوحاتك ؟
لا أتردد بالتجريب والاكتشاف، ولا أتوقف عند خامة واحدة أو اثنتين. اشتغلت على خامات كثيرة، وأفضل كثيراً الاشتغال على الخشب، لسبب بسيط جداً، أشعر أنني أعطي حياة أخرى لتلك الشجرة التي قطعت ليصنع منها الخشب. ألغي فكرة موتها، أعطيها شيئاً من روحي لكي تعيش. كما أجد الخشب مادة مطاوعة، ويمكن التصرف بها بشكل كبير. صلابتها تعطي شعورا جميلا .
لماذا تفضل في تجربتك الفنية استخدام تقنية الجرافيك المحفورة؟
الحقيقة أنا أشتغل بروحية فن الجرافيك، وليس بتقنية الجرافيك الحرفية. واللوحة التي أنجزها لا يمكن تكرارها. أما في فن الجرافيك ففيه ميزة تكرار اللوحة بعدد من النسخ المتشابهة، وأول لوحة من هذا الفن استخدمها الصيينون على الورق والحفر على الخشب . طبعا باستحضار أنواعه، ومن ذلك الطباعة من سطح بارز، الطباعة من سطح غائر، الطباعة من سطح مستوي.
كيف تنظر إلى طبيعة المشهد التشكيلي العراقي في علاقته بالمحلية والكونية؟
الإجابة على هذا السؤال، قابلة لأن تقدم بشكل سالب أو إيجابي، بمعنى موضوع تطور الإنسان أو الفنان يعتمد على الاستعداد أولا، والجهد بالبحث والتجريب ، أو الاكتفاء بما وصل إليه الفنان، ليكون سجين الخصوصية التي يعتقدها ربما. أو رهينة لصعوبة الابتكار والحصول على فكرة لمشروع فني جديد. وهذا ممكن جداً، وأنا شخصياً عانيت من هذا الموضوع في بداياتي الفنية، فقد رسمت اللوحة الأولى وتسمرت ماذا بعد ؟ ليس من السهل أن تجد فكرة، وربما تجد الفكرة، ولكن تقع في مشكلة التنفيذ، لذلك تجاوزت الموضوع بالبحث والتجريب المستمر. أما ما يتعلق بالخصوصية، لو توقف عندها الفنان سيكون كمن يدون رواية أو قصيدة ويعيدها كل مرة، أين الجديد بالموضوع ؟
برأيي الخصوصية أسلوب كما الأسلوب الكتابي فيها نفس وروحية. تتغير فيها الأحداث والصور بالنسبة للكتابة، والخامات والأفكار بالنسبة للرسم ، بعيداً عن التكرار. لذلك أستطيع القول أن بعض الفنانيين مازالوا يراوحون في أماكنهم، والبعض اشتغل على نفسه، وأجهدها بالبحث والتجريب ومتابعة التطورات لتحقيق النجاحات، ولعل هذا هو المطلوب .
مشهدية الحركة التشكيلية في العراق متحولة تبعا لسياق كلامك، هل لهذا الأمر علاقة براهن الحياة الفنية بالعراق؟
واقع الحال اليوم يرتبط بظروف العراق المأساوية التي أثرت كثيراً على جميع جوانب الحياة، والحالة النفسية للإنسان مؤلمة، فكيف بالفنان الذي يتعامل بالحس والمشاعر. بالتأكيد هنالك تأثير كبير وواضح، عدد كبير من قاعات الفنون التي كانت تنتشر في بغداد أغلقت، وعدد كبير من الفنانين هاجروا، ومن بقي منهم في الداخل يصارع صعوبة الحياة بأجواء ملغومة ومشحونة بسوء الخدمات، والطائفية المقيتة، والعوز،وقلة الأمان،والعنف. ومع كل هذا فجمعية الفنيين التشكيليين العراقيين برئاسة الفنان المبدع قاسم سبتي، تقيم أنشطة نوعية ومميزة، وكذلك تصدر الجمعية مجلة خاصة تهتم بالتشكيل بطباعة أنيقة وبحرفية عالية. أعتقد الأمر بالدرجة الأولى، ترسمه ظروف البلد السياسية والاقتصادية .
هل يمكنك الحديث عن بعض التجارب التشكيلية العراقية التي حققت نجاحات خارج الوطن؟
العراق مهد اللإبداع والمبدعين في كل المجالات التعبيرية، وفي المجال التشكيلي على وجه الخصوص. لا أود أن أذكر اسماً لئلا أنسى آخر، وسيكون ظلم بحق من أنساه، ولكن أستطيع الإجابة بالقول أن الكثير من الفنانيين العراقيين حققوا نجاحات كبيرة وهامة، واستطاعوا أن يثبتوا نفسهم بقوة في المشهد الثقافي العربي، و في ديار الغربة التي صارت قدرنا، وكيف لا ونحن خارجين من مصهر الإبداع الحقيقي، العراق المجيد.
هل لازلت مسكونا بالرغبة في التجديد الفني في تجربتك التشكيلية؟
البحث الدائم لا يترك لي مجالاً للوقوع في مشكلة التكرار، والتجربة المستمرة تزيد من خبراتي وتفتح لي أبوابا لمشاريع فنية غير منقطعة. أستخدم مواد مختلفة ومتنوعة بعضها ليس له علاقة بالرسم. السكين والفرشاة والألوان أدواتي، لكنها ليست أدواتي الوحيدة، وأنا أقوم بمعالجة للون ليعطيني روحية العتق أو القدم كي يتناسب مع الموضوع الذي أشتغل عليه.
هل اشتغالك على الأثر الفني العراقي ساهم في خصوصية اللوحة التشكيلية على مستوى المساحة؟
كوني أشتغل على الأثر ومفهومه، حرصت أن أعطي لعملي الفني شكلاً قريباً من الآثار. وهذا الشكل أعطاها خصوصة وجمالية، وكأن اللوحة أخرجت تواً من باطن الأرض. في أعمالي الأخيرة عملت على تقطيع اللوحة بالكامل ليس الحواف فقط وإعادة تجميعها بلوحة، قطعة قطعة، وكأن الزمن كسر أجزاءها، وأعيد صفها وكأنها قطعة أثرية أو رقعة من الموزاييك. وهذا يتطلب مني عملاً مضاعفاً. أرسم وأقطع وأعيد البناء باحترافية عالية مع احتساب الجوانب الفنية والجمالية لأجعل منها قطعة فريدة تثير الإعجاب وتطرح التساؤلات. وقد ساعدني في ذلك الموضوع امتلاكي لمهارات إبداعية أخرى، مثل التصميم الطباعي، وتصميم الديكور، والنجارة , وظفت هذه المهارات داخل عملي الفني , ليكون قوياً ورصينا.
هل تسعى إلى تحويل لوحاتك الفنية إلى مجال للتفكير حول الإنسان والهوية، والتساؤل عن الفن نفسه؟
لا أميل إلى البساطة أو التقليدي في العمل الفني. أبحث في الأعماق، فالفن حسب منظوري ليس أن تكتفي برسم شمس أو قمر أو نهر أو جبل، بل هو أبعد من ذلك بكثير. أستحضر في هذا السياق قول الفنان الأسباني بابلو بيكاسو: (بعض الرسامين يحولون الشمس إلى بقعة صفراء، والبعض الآخر يحولون البقعة الصفراء إلى شمس). والعمل الذي يثير التساؤلات أكثر غنى. التساؤل يجعلنا نبحث، والبحث يجعلنا نكتشف ونتعلم، لا يقنعني أبداً عمل أنجزه، ولا يثير التساؤل داخل نفسي، إذا لم يثرني فكيف له أن يثير الآخرين ؟
الإثارة تتكون لدي من لحظة تأمل تسبق العمل، وتخيل كامل لصورة وطبيعة العمل الفني، لحظة التأمل هذه تشبه حالة الإلهام. وعندما أبدأ عملي أترك لأصابعي الحرية المطلقة بالحركة بالفرشاة والألوان، وأنسى نفسي أمام ضربات الفرشاة وحبكة اللون. لا أبالغ إن أنا أسميتها حالة غيبوبة تتخللها حالة حوار مع اللوحة في أخذ وعطاء، تطلب مني لون هنا وخربشة هناك إلى أن تكتمل، وترفض أن أزيدها من الألوان، أنهي عملي بها، وأتركها بعض الوقت ليوم أو أكثر، لأرجع إلى حالتي الطبيعية، وأضعها أمامي على الكرسي، أحتسي الشاي وأتأملها بهدوء، وكأنها حبيبتي. نتحاور بصمت، أنظر إليها بإعجاب، وأبدأ بالتساؤل من جديد. و أعتقد أن هذه الحالة، وهذه التساؤلات يعيشها المشاهد، وبهذا استطعت أن أخلخل أو أحرك شيئاً في داخله ليضع علامة استفهام هنا وهناك.
كيف يتحقق فضاء المكان بمرجعياته التاريخية والدرامية ( الحارة مثلا) في لوحاتك التشكيلية؟
الحارات البغدادية أو كما نسميها في العراق (الشناشيل) الموضوع الأول الذي اشتغلت عليه، وقدمت معرضي الشخصي الأول كما أسلفت في 1997 بعنوان :”بغداد حبيبتي”. هذه الحارات عشت بها منذ ولادتي، وطفولتي الأولى، رغم أنني جنوبي المنشأ، من مدينة العمارة تحديداً، البيوت القديمة تثيرني بأزقتها الضيقة، وهندستها الجميلة، بأبوابها، وشبابيكها المميزة، ومكامن الضوء، والظل، المثير لعدسة العين والكاميرا. من الطبيعي جداً أن يكون هذا الموضوع مؤثراً للفنان الذي يبحث عن الأصالة والجمال. وفي تلك الفترة كنا نعاني من ظروف حصار اقتصادي خانق جداً في العراق، وهجرة شبه جماعية، لذلك رسمت بغداد بأزقة خالية، وجدران متشققة تعبيرا ًعن الفقد والخسارة، وامرأة ترتدي السواد في طريق المغادرة أو الرحيل. بعد هذا الموضوع اشتغلت على الأبواب الإسلامية والأثر الإسلامي القديم ، وقمت بتوظيف الخط العربي في لوحاتي كوني خطاط أيضا، وعضوا لجمعية الخطاطيين العراقيين. وبعد فترة من التجريب والبحث المتواصل اتجهت نحو الأثر التاريخي: رموز قديمة، قطع أثرية، رقم طينية قديمة. ومازلت أشتغل على هذا الكنز الذي لا ينضب. أشعر ب”تسونامي” يتدفق في داخلي عسى أن أستطيع أن أطارد فكرة في داخلي، ” أن الأحفاد خربوا ما صنعه الأجداد”. ربما يسعفنا علم النفس الاجتماعي لفهم هذه الإشراقة المنيرة في قول الفنان بابلو بيكاسو:” تاريخ بلاد الرافدين هو أعظم ما خلفته الحضارات القديمة للإنسانية”. وللسبب نفسه يتساوق الأثر الجمالي لتجربتي الفنية في ملمحها الجمالي، مع مع الأثر الجمالي لحضارة العراق المجيدة.